 2015-01-21, 03:25 PM
2015-01-21, 03:25 PM
|
#2
|
|
قلـــــم فضـــي
تاريخ التسجيل: 2012-03-02
المشاركات: 2,633
|

الخطاب الثقافي وإغراء الجماهيرية
الخميس 10 شعبان 1428هـ - 23أغسطس 2007م - العدد 14304
محمد بن علي المحمود
* تتمتع الجماهيرية بسحرها الذي لا يقاوم. إنها نوع من الإغراء الغرائزي الذي قد يلتهم النفس البدائية المشدودة بقوة إلى عواطفها؛ حتى يكتسح كل أنواع الإغراء الأخرى. غاية المنى، أن تصفق لك الجماهير الغفيرة بقلوبها قبل أكفها، فذلك - في نظر الكثير - الفوز المبين، والسعادة التي يبذل في سبيلها كل غالٍ؛ ولو كانت الحياة نفسها. إنها ليست مجرد إشباع غرائزي، يمكن أن تلهو به الرموز في هذا الميدان أو ذاك، وإنما هي ممارسة تنتهي بتراجع المعرفة، وضمور الإنسان.
إن إغراء كهذا، ترخص الحياة في سبيله، حقيق أن يأخذ حظه الوافر من القراءة والعرض؛ كيلا تصبح المعرفة ذاتها من القرابين التي تقدم لإرضائه، كما هو واقعنا اليوم، بل وربما قدمت إنسانية الإنسان - وهنا تقع الكارثة - ثمنا لهذا الإغراء الغرائزي. إضاءة - وربما تعرية وفضح - هذا الاستغلال - غير البريء - لعواطف الجماهير، من قبل الفاعل الجماهيري، ومن قبل القنوات الإعلامية الجماهيرية، جزء من مسلك معرفي، يتغيّا وقف الاتجار بالإنسان أولا، كما يتغيّا حفظ المعرفة من هذا الابتذال الرخيص.
الجماهيرية حالة (عاطفية) قبل أن تكون وجوداً متعينا. إنها حالة تخلّقت بفعل التصعيد العاطفي، الذي يتجاوز بالإنسان حدود الإنساني، إلى ما قبل الوعي الإنساني بالإنسان. وهذا يعني أن الخطاب يتجمهر، بقدر ما يتنازل عن الأبعاد العقلانية التي يشترطها سياقه. و لهذا أكد جوستاف لوبون في كتابه: سيكولوجية الجماهير، على أن التجمهر، ولو من قبل أناس عرفوا بمستوى ما، من العقلانية، يؤدي - بالضرورة - إلى التنازل عن شيء من الرؤية العقلانية، لصالح العاطفة الجماهيرية الهوجاء.
إذن، فطبيعة الخطاب العقلاني، تفترض فيه - ابتداءً - أنه خطاب غير جماهيري، كما أن طبيعة الخطاب الجماهيري، تفترض فيه - من حيث هو جماهيري -، أن مستوى ما، من العقلانية قد تمت التضحية به، في سبيل تحقيق هذا البعد الجماهيري.
من هنا، ندرك التلازم الذي نراه في واقعنا المحلي، بين تقليدية الخطاب المضادة لكل ما هو عقلاني، وبين رواجه الجماهيري الكاسح. كلما أمعن الخطاب التقليدي في البعد الخرافي، وكلما كان انتهازيا في استغلال عواطف الجماهير، تصاعدت جماهيريته. إن الجماهير بطبيعتها لا يمكن أن تحافظ على الحد الأدنى من الالتزام بالشرط العقلاني؛ لأن ذات التجمهر المشبوب بالعاطفة، لم يتكون إلا بالإجهاض المتعمد لهذا الشرط العقلاني.
الخطاب التنويري - وهو خطاب عقلاني بالضرورة - يعي أنه خطاب غير جماهيري، لا لنقص يطال بنيته المعرفية، أو سلوكه الواقعي، وإنما لأنه ملتزم بالشرط العقلاني الذي يستلزم حدا أدنى من الالتزام المعرفي. والمعرفة - وأقصد: المعرفة الحقة الملتزمة بالشرط المعرفي - ليست سهلة، لتكون في متناول الجميع الجماهيري. ولهذا كان اكتساب شيء من هذه المعرفة التي تمنح الإنسان صفة: العلمية، يستلزم اقتدارا ذاتيا، وعناء متواصلا، ليس في مقدور الأغلبية الساحقة من الجماهير، وإلا لأصبح الناس - جميعا - علماء!.
لا يعني هذا أن الخطاب التنويري لا يسعى لتحقيق نفسه في الجماهيري. إن هذا هدف من أهدافه، وبقدر تعميم الوعي التنويري على أكبر شريحة ممكنة، يتحقق التقدم المأمول للتنوير. لكن، الخطاب التنويري، وهو يسعى لتحقيق هذا الهدف، يلتزم بعدم التنازل عن الشرط العقلاني/ المعرفي الذي يحدد جوهر هويته. ولأنه ملتزم بهذا، فهو يدرك أن نجاحه في الوصول إلى نوع من الجماهيرية، سيبقى نجاحا محدودا بحدود الالتزام بالشرط العقلاني/ المعرفي.
من هنا، نفهم طبيعة الغموض، الذي يسم الخطاب العقلاني/ المعرفي، والذي يشكو منه بعضهم، وبعضهم يعتبره - بسذاجة تتجاوز حدود الغباء والجهل - سلوكا متعمدا من قبل الفاعل التنويري. الغموض هنا، لا يفهمه التقليدي، أن بوصفه غموضا في الأسلوب، والأسلوب عنده ليس نمط تفكير، وإنما هو مجرد: وسيلة نقل للمعلومة!. وهذا تصور تقليدي للأسلوب، الذي يجعل اللغة مجرد أداة توصيل، والتمايزات الأسلوبية مجرد زخارف بلاغية، يمكن التنازل عنها، دون المساس بالمعرفة المنقولة عبر هذا الوسيط.
اللغة ليست أداة توصيل فحسب، وإنما هي بنية تفكير. والتمايز الأسلوبي في اللغة الواحدة، لا يعني مجرد التنوع في قنوات التوصيل، وإنما يعني تنوع أنماط الرؤية عند أبناء اللغة الواحدة. كون الأسلوب - بمعناه الواسع - نمط تفكير، يعني أنه نوع من الوعي، من حيث كون اللغة وجوداً قبلياً، يسبق النطق أو الكتابة. ولكن التقليدي يبقى أسير تصوراته الساذجة عن اللغة، المشدودة إلى التصورات البلاغية العتيقة، بل العتيقة جدا، إلى ما قبل ألف عام!.
من خلال هذا التصور لطبيعة اللغة، وعلاقتها بالتفكير، جاء الخطاب التنويري - وأقصد الخطاب التنويري الحقيقي، الملتزم بكونه تغييرا في نمط التفكير، وليس مجرد اقتناع بمفردات التنوير - متلبسا بنوع من الغموض. وهو غموض نابع من طبيعته، أي من نمط تفكير. وهذا ما جعل الحل التنويري، إبان محاولته الوصول إلى أكبر قدر من الناس/ الجماهير، يتعمد حث الناس على الاشتباك مع هذا المستوى المعرفي، ويمارس عملية الارتقاء بالمتلقي، بدل أن يتخذ الدور الأسهل، وهو التنازل عن نمط التفكير، أي عن جوهر التنوير ذاته؛ لأنه يدرك أنه لو فعل هذا، لفقد الخطاب مشروعيته من الأساس.
لكن، مشكلة المجتمعات التقليدية، أنها مشدودة - بقوة - إلى الجماهيرية، بل تصل أحيانا إلى جعل مستوى الجماهيرية، دليلا على مستوى صوابية الأفكار، فكلما تصاعد المد الجماهيري لخطاب ما، أصبح - في نظرهم - دليلا على تصاعد الإيجابية الصوابية فيه. ولهذا، تحتفل الخطابات التقليدية بمهرجاناتها التي يختلط المعرفي بالاجتماعي، وتسعد بالمد الجماهيري الذي يتحقق بقوة العاطفة، وضمور العقل، وليس بقوة الأفكار، ومستوى نجاعتها.
لا تستطيع المجتمعات التقليدية - والخطاب التقليدي من باب أولى - أن تفصل بين القيمة الاجتماعية والقيمة المعرفية. وبما أن هذه المجتمعات مهمومة بالمكانة الاجتماعية؛ لأن الكل ينظر إلى الكل، فقد تم تحويل كل شيء إلى وسيلة للرقي في التراتبية الاجتماعية، حتى المعرفة ذاتها. ولهذا نفهم كيف يصبح للتلبس بالمعرفي، ملبس خاص، يحدد المكانة المعرفية، من حيث هي قيمة اجتماعية، أو يحدد المكانة الاجتماعية، في الوقت الذي يحدد فيه المكانة المعرفية.
التقليدي يسعد بهذا. فهو في اجتراره ما يظنه علما، تتحقق له - كمكافأة آنية - المكانة الاجتماعية. وإبان هذه الممارسة، يكتسب مهارة الحفاظ على هذه المكانة، عبر الولاء التام - غير الواعي - لمقولات التقليد، وعبر المزايدة - غير البريئة - على مقولات التشدد. وهذا يفسر لنا ظهور الفتاوى المتشددة التي تصل إلى تخوم التكفير، بين الحين والآخر، من قبل رموز التقليد. إنها ليست أكثر من محاولة الحفاظ على مكانة اجتماعية ما، تتم عبر امتهان المعرفة بالتنازل عن شروطها، للتلاعب بعواطف الجماهير.
مأساة التقليدي، أنه قد يؤخذ بشيء من مفردات التنوير، فيحاول الاشتباك معه في هذا المضمار أو ذاك. يفعل ذلك، وعينه على الجماهيري. إنه - جراء سابقته التقليدية - ينتظر المكانة الاجتماعية من خلال الاشتغال على المعرفي. وبما أن التنوير - كما اتضح مما سبق - ليس خطاباً جماهيرياً، فإنه يصدم بعد كل جهد، لا يجد الجماهيرية التي يتمتع بها أدنى فاعل تقليدي. إنه ينتظر قبلة على الرأس، وفي الجبين، ويحن لتلك الأصوات اللاهثة عن يمينه وشماله، بعد كل محاضرة، ولكنه لا يجد شيئا من ذلك يحدث بعد الانتقال إلى دوائر التنوير.
هنا، يبدأ إحساس التقليدي بالفشل، وبأنه بالاشتباك مع مفردات التنوير قد خسر الكثير. إنه ليس فشلا في الحقيقة، ولكنه بالنسبة إليه، يعده فشلا؛ لأنه - في أعماق وعيه - ليس باحثا عن معرفة، بل ولا عن إصلاح براجماتي، وإنما هو باحث عن مكانة اجتماعية. وعندما لم تتحقق له هذه المكانة، على الصورة التي يطمح إليها؛ لأنه ليس في الخطاب التنويري زعامات مقدسة، فضلاً عن قبلات على الرأس والجبين، ولهاث محموم للتبرك بالعباءات المباركة!، فإن هذا التقليدي السابق، يحن إلى عشقه القديم.
ومن أجل الرجوع، والظفر بالمكانة الاجتماعية المفقودة، يبدأ التقليدي العائد، بمغازلة رموز التقليد، والقنوات الإعلامية التي تتمكن من إعلان توبته النصوح على الجميع. وجراء هذا الشوق الباحث عن موقع ما، يكون على استعداد لتقديم المهر المطلوب. حينئذٍ، قد يحظى بما لم يستطع الخطاب التنويري تقديمه له، فتستضيفه قناة (ألا يا لا!) المباركة!، ويقدم - في وهج هذه الاستضافة - المهر المطلوب، ثناء بالمجان على زمن (الغفوة) المباركة. وكل شيء مبارك هنا!.
هكذا يقع الكثير في غواية إغراء الجماهيرية، إلى درجة السقوط في براثن التقليدية في أشد صورها مأساوية. إنها لحظة ضياع، كان الانشداد للمكانة الاجتماعية مقدمتها الضرورية، ولولاها، لاستطاع بعضهم التماسك، ولو - على الأقل - عن إغراء القنوات الإعلامية الجماهيرية، التي يدرك أنها تمارس دورا تجهيليا خطيرا، بحيث يكاد - بسببها - أن ينغرس فيروس التخلف في وعي الأمة، إلى درجة غير قابلة للشفاء.
لا أدري إلى متى ستستمر هذه المأساة. لكن، لا شك أنها ستبقى على هذه الدرجة من البشاعة؛ ما دام التنوير يؤخذ على هذا النحو من التبسيط، الذي يصل إلى درجة أن يتصور بعضهم، أنه يستطيع تحقيق جماهيرية، لم يستطع تحقيقها في ميدان التقليد. التنوير خطاب في المعرفة، وهو - بضرورة ذلك - خطاب غير جماهيري. ومن يبحث عن الجماهيرية، ويريد أن يحقق من خلالها مكانة ما، فعليه أن يبحث عنها بعيدا عن خطاب التنوير.
|

|
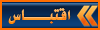
|